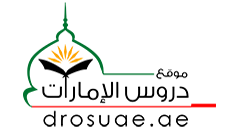مختارات من فتاوى الصيام
تأليف: فضيلة الشيخ د.عزيز بن فرحان العنزي
صيام شهر رمضان واجب، وهو ركن من أركان الإسلام،
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]
وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[البقرة: 185]
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»([1])
ورد في فضل شهر رمضان نصوص عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف، وأنا هنا أشير إلى بعضها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك:
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»([1]).
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ -أَوْ أَحَدُهُمَا- الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ» ([2])
- وَعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»([3])
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([4])
- وَعَن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «…إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً». وفي رواية: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» ([5])
- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»([6]).
([2]) حديث حسن صحيح، رواه: أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان، وقال: حسن غريب.ا.هـ. وله طرق عن أبي هريرة، وفي الباب عن جابر وكعب بن عجرة وغيرهما.
([6]) حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ،وصححه ابن حبان والحاكم.
من أفطر في نهار رمضان عامدًا متعمدًا فهو فاسق يستحق العقوبة الزاجرة له في الدنيا، وهو متوعد بالعذاب في الآخرة، فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، …وفيه..: ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ([1])…». الحديث([2])
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»([3])
والواجب عليه قضاء ما أفطره من الأيام، والتوبة والاستغفار والندم على ما صدر منه تجاه حق الله تعالى، ويكثر من الأعمال الصالحة، ومنها صوم الأيام المندوبة؛ كالاثنين والخميس، والأيام البيض، وعرفة، وعاشوراء، وأسأل الله أن يتوب عليه.
([1]) قال المنذري في الترغيب والترهيب: وَقَولُهُ «قبل تَحِلَّة صومهم» مَعْنَاهُ: يفطرون قبل وَقت الْإِفْطَار. ا.هـ.
([2]) حديث صحيح، رواه: النَّسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه ابن خُزيمة، وابن حِبَّان، والحاكم، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ا.هـ.
([3]) حديث صحيح، رواه: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي: “رجاله ثقات”. ورواه: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعًا به. وسنده فيه جهالة. وعلقه البخاري تعليقا غير مجزوم به. وقال الذهبي في “كتاب الكبائر”: (وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض؛ فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال).
من ترك الصوم جاحدًا لوجوبه فهو كافر بإجماع العلماء إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، وأما إن كان تركه للصيام تهاونًا فلا يكفر، ولكنه يُفسّق، وهو على خطر كبير بتركه رُكنًا من أركان الإسلام أجمعت الأمة على وجوبه، ولا شك أنه يستحق العقوبة الرادعة له والتأديب من ولي الأمر، ويجب عليكِ أن تقدمي له النصيحة باستمرار، وأن تتمنعي عنه لعله يتوب وينزجر عن مثل هذا الفعل القبيح.
لا شك بأن الأهل يتحملون إثمًا كبيرًا على هذا الإهمال، فهم مسؤولون عن تعليمك أحكام الإسلام من قبل البلوغ، وأنتِ أيضًا تتحملين إثمًا؛ وذلك لتساهلك في تعلم حكم صوم رمضان، ولا يتصور أبدًا أنك لا تعرفين الصيام وأنت تشاهدين أهلك ومن حولك إذا جاء شهر رمضان يصومون، ولا يتصور أيضًا أنك لم تقرئي عنه في المناهج الدراسية، أو حديث صديقاتك إذ لا بد أن يأتي على ذكر الصيام، أو مشاهدة البرامج الإعلامية عن الصيام، عمومًا عليك التوبة والاستغفار، والإسراع في قضاء الأشهر التي فاتتك منذ بلوغك؛ فذمتك مشغولة بهذه الأشهر، وأسأل الله أن يتوب عليكِ، كما أسأله جلّ وعلا أن يعينك على قضاء هذه الأيام.
لا يجوز له الإفطار؛ لأن الامتحانات ليست عذرًا شرعيًا يرخص له في الإفطار في رمضان، فمن أدرك رمضان بالغًا عاقلًا مقيمًا فيجب عليه صومه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، إلى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
وأنصح أولياء أمور الطلاب بأن يشجعوا أولادهم على الصيام وأن يبينوا لهم فضله، ولا تكون عاطفة الأبوة سببًا في تساهل أبنائهم وتفريطهم في الصيام، ومعلوم أن الصائم إذا تناول السحور بشكل جيد فإن الله سيبارك له، وأيضًا عليكم أن تذكروهم بأهل المهن والحرف كيف يعملون تحت الشمس الحارقة في نهار رمضان ولا يفطرون، والمعونة من الله ، والله هو الهادي.
أسأل الله لك الإعانة، أخي لا بدَّ أن تعلم أنه يجب على المسلم صوم شهر رمضان ما دامت شروط وجوب الصوم قد توفرت فيه وهي: الإسلام والعقل والبلوغ، ولم يكن مريضًا ولا مسافرًا ؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فالواجب عليك عدم التساهل في صيامه، فيجب عليك من الليل أن تنوي صيام نهاره، وإذا شعرت أثناء صومك بإعياء وتعب، وكنت تعتقد بأنك لا تستطيع إكمال الصوم؛ جاز لك الفطر في مثل هذه الحال، وعليك أن تقضي بعد رمضان.
لا يجوز إجبار الطفل الصغير الذي لم يبلغ على الصيام، ويتأكد التحريم إذا كان لا يطيقه، وربما تسبب الصوم له بمرض أو مضاعفات. وأما إذا كان الصبي يطيقه فينبغي تعويده عليه خاصة إذا قرب عمره من البلوغ أو بلغ العاشرة ليتدرب عليه، وإذا صام فله الأجر، وكذلك لوالديه الأجر والثواب، وإذا صام وجب أن يُعلم مفسدات الصوم حتى يجتنبها.
يجب على وليِّ الطفل أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربه عليها إذا بلغ عشرًا ولم يصلِّ، وتتعين الصلاة على الصبي إذا جرى عليه القلم، ويجري القلم إذا بلغ؛ والبلوغ يحصل بأحد أمور:
- بإنزال المني عن شهوة.
- وبإنبات الشعر الخشن حول القبل.
- وبالاحتلام إذا أنزل المني.
- أو بلوغ خمس عشرة سنة.
- والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض.
والأصل في ذلك ما ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»([1]). وَأيضا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»([2])
أما الصيام، فيؤمر به الصبي ليعود عليه إن كان يطيقه، فإذا بلغ أمر به وجوبًا.
([1]) حديث حسن صحيح، رواه: أحمد، وأبو داود، وله شاهد أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه.
([2]) حديث حسن صحيح، رواه: أحمد والنسائي وابن ماجه، وابن الجارود في المنتقى، وصححه ابن حبان، وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب.
إذا بلغ الصغير عاقلًا فقد وجب عليه الصيام، كما تجب عليه بقية التكاليف من الصلاة وغيرها، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»([1]).
فالواجب عليكم أمره بالصيام وترغيبه في ذلك وتشجيعه عليه، وبيان الفضل الكبير لمن صام، واهتموا بإيقاظه وقت السحور؛ لأن في السحور بركة، ومع مرور الوقت سيجد قدرة على الصيام. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم ولجميع المسلمين. آمين.
يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[البقرة: 185]. فإذا لم يرَ الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان ثلاثين يومًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»([1]).
([1]) متفق عليه واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه. مرفوعًا: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ». رواه الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري.
أجمع العلماء على أن الشهر القمري تارة يكون تسعًا وعشرين ليلة، وتارة يكون ثلاثين، ودليل الإجماع ما ثبت عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا»؛ يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ([1]).
وقد علق الشارع الحكيم دخول الأشهر وخروجها عمومًا بالأهِلّة؛ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]
وعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» وفي رواية: «… فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ»([2])
فهذه النصوص – وغيرها كثير- تدل على أن الواجب هو اعتماد الأهلة في دخول الشهر وخروجه، وما يقوم به من ذُكِروا في السؤال من الاستمرار على الصيام لمدة ثلاثين يومًا على الدوام؛ عمل خطأ ومنكر عظيم؛ لأنه مصادم للنصوص الشرعية، ومخالف لإجماع المسلمين، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من هذا التنطع، وعدم العود إلى مثل هذا العمل، والواجب عليهم سؤال أهل العلم فيما يشكل عليهم.
([1]) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
([2]) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الواجب عليكم أن تلتزموا الصوم مع أهل بلدكم، ولا تخالفوهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»([1]). والاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وفق الله المسلمين لاجتماع كلمتهم على الحق والهدى.
([1])حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب. وله طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه .
لقد بيّن الله جل وعلا حقيقة الصيام بقوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة: 187]؛ فجعل الصوم ما بين هذين الوقتين، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولم يخص بلدًا دون بلد، سواء قصر النهار أم طال، فالواجب عليكم الصيام ولو طال عليكم النهار؛ لأن الزمان سيدور وتصومون وقتًا يسيرًا، ومن عجز عن إتمام صوم هذا اليوم لطوله أو كانت له تجربة سابقة وما استطاع الصيام، أو غلب على ظنه أن الصوم يؤدي إلى وقوعه في المرض والحرج الشديد؛ فإنه يفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها ولو في فصل الشتاء.
كل بلد أو جهة يتمايز فيه الليل والنهار بحيث يشاهد الناس طلوع الشمس وغروبها فإنه يجب عليهم صوم ذلك اليوم من رمضان من طلوع الشمس إلى غروبه؛ قصر النهار أو طال، وأما إذا كان البلد أو الجهة لا يتمايز فيها الليل من النهار، مثلما هو موجود في بعض الدول الإسكندنافية، بحيث إنهم لا يرون قرص الشمس مدة ستة أشهر؛ فإنهم ينظرون إلى أقرب بلد إليهم سواء في الجهة نفسها أو الدولة نفسها؛ وإن لم يوجد فالدولة القريبة منهم التي يتمايز فيها الليل والنهار فيقدرون النهار والليل بعدد الساعات التي عليها بلد التمايز ويصومونها.
نعم لها وقت، وهي تختلف باختلاف نوع الصيام، فأما الصوم الواجب، وهو صوم رمضان، أو صوم النذر، أو صوم الكفارات، أو قضاء رمضان، فلا بد أن تكون النية من الليل وقبل أن يدخل عليه الفجر الصادق، لما ثبت عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»([1]).
وأما صوم النفل فالصحيح من قولي أهل العلم: أنه لا يجب تبييت النية من الليل، وذلك لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»([2]). وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَتَى أَصْبَحْتَ يَوْمًا، فَأَنْتَ عَلَى أَحَدِ النَّظَرَيْنِ، مَا لَمْ تَطْعَمْ أَوْ تَشْرَبْ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»([3]).
وَعَن عِكرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ حَتَّى يُظْهِرَ، ثُمَّ يَقُولُ: «وَاللهِ لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَمَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَمَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَلَأَصُومَنَّ يَوْمِي هَذَا»([4]).
([1])حديث رجاله ثقات، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن رجَّح وقفه الأئمة: أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم. وروى الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه النسائي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ». وإسناده صحيح.
([3]) أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا، والطحاوي في شرح معاني الآثار، واللفظ له.
([4]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار.
لقد رغّب الشارع الحكيم في صوم النفل وسهّل أحكامه، كبقية المندوبات، ولذلك من طلع عليه الصبح، ولم يباشر أي نوع من المفطرات؛ جاز له أن ينوي صوم هذا اليوم، ولكن اختلف الفقهاء في الحد الذي يشرع للصائم نفلًا أن يبدأ نية الصيام على قولين اثنين من حيث كونه قبل الزوال أو بعده، والصحيح من قولي أهل العلم أنه يصحّ أن ينوي قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا؛ لأنه قد مضى أكثر النهار([1]).
([1]) وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ طَعِمَ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَائِمًا». وفي مصنفي: ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، عن ابن عباس رضي الله عنه مثله، وروى عبد الرزاق عن جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ». وفي سنده انقطاع. وفي المصنف أيضًا عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ». وفي سنده مبهم.
رفض زوجك للصيام دليل على قطعه لنية الصوم، فيكون قد أبطل صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»([1])، ومعلوم أن النية شرط لصحة الصوم، ومن شرطها استمرارية النية من دون قطع إلى آخر العمل، وخلو يوم من رمضان من نية أو رفضها يبطل صوم ذلك اليوم، فيكون عليه القضاء.
الواقع أن هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب النية لكل ليلة، وذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق إلى أنه يجزئه نية واحدة من أول الشهر، إلا إذا أفطر في رمضان لعذر؛ كالمرأة الحائض والمريض والمسافر فيستأنف النية، بمعنى يبتدئ النية من جديد، قالوا: لأن رمضان عبادة واحدة، وأيامه متتابعة، فيكفيه نية في أوله.
أولًا: يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسألوا أهل العلم، ولا يسألوا أهل الجهل!! فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43، الأنبياء: 7].
ثانيًا: هذا القول مخالف لإجماع أهل العلم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على جهل قائله.
ثالثًا: أجمع العلماء على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة أثناء فترة الحيض، وقاسوا عليها النفساء، وأن الحائض تقضي الصوم بعد الطهر ولا تقضي الصلاة، فَعَن مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»([1]).
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»([2]).
([1]) رواه: البخاري، ومسلم، واللفظ لمسلم.
لقد علق الشارع الحكيم أحكام الحيض على رؤية الدم، فمتى ما رأت المرأة دم الحيض فقد فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، وأما إذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض وشعرت بآلام الدورة ولكن لم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس؛ فإن صومها صحيح، ولله الحمد، يبقى عليك أختي السائلة صلاة العشاء إذا لم تكوني قد صليتها فستقضينها بعد الطهر.
نعم يجوز بشرط عدم حصول ضرر عليك من هذه الحبوب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»([1]).
وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن للمرأة الحائض أن تبقي الأمور على طبيعتها، وأن ترضى بما كتبه الله على بنات آدم ([2]).
([1]) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة وثعلبة القرظي وأبي لبابة رضي الله عنهم. وانظر: إرواء الغليل (896).
([2])ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنُفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».
صومك صحيح، ولا تقضين هذا اليوم؛ لأن الإفرازات والكدرة والصفرة والخيوط التي تنزل بعد الطهر ليست بشيء، لقول أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ [بَعْدَ الطُّهْرِ] شَيْئًا»([1]).
([1])أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والزيادة لأبي داود.
أختي لا يجوز للإنسان أن يتهاون في أوامر الله تعالى، وعليه أن يبادر إليها أداء وقضاء، وهذه الأيام التي لم تكوني تقضينها ذمتك مشغولة بها الآن، والله يطالبك بها، فالواجب عليك المسارعة إلى قضائها وإبراء ذمتك منها، وعليك أن تحصيها ثم تنوي قضاء الأول فالأول. وتستطعين معرفتها من خلال عدد أيام دورتك، فإن التبس عليك الأمر بحيث لم تعلمي بالتحديد فعليك أن تصومي حتى يغلب على ظنك أنك أتيت على هذه الأيام كلها في الرمضانات السابقة.
وبالمناسبة أنبهك إلى أمرين:
الأول: لا يشترط التتابع في القضاء، وإن كان هو الأفضل.
والثاني: عليك إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي لم تقضيها متعمدة حتى دخل رمضان الذي بعده.
لقد أخطأت خطأ كبيرًا حينما تركت الصوم وأنت قد طهرت من النفاس، فالأربعون التي يذكرها الفقهاء هذه هي أقصى مدة النفاس عند كثير من أهل العلم، ولا يقصدون أن المرأة لا تطهر مطلقًا قبل الأربعين ولو رأت الطهر، فالواجب على المرأة النفساء بمجرد رؤيتها للطهر أن تغتسل وتصلي وتصوم، والطهر يعرف بشيئين: القصة البيضاء، والنقاء التام الذي هو الجفاف مدة يوم وليلة لا ترى فيه الدم، فعليك الآن قضاء صلوات هذه الأيام، وأيضًا قضاء صيامها، وأيضًا يجب عليك تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالدماء.
نزول دم الحيض من مفسدات الصيام بإجماع العلماء، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»([1]).
([1]) رواه: البخاري، ومسلم، ونحوه عن ابن عمر.
إن كان تقيُّؤك بغير اختيارك وإنما غلبك فصومك صحيح، وأما إذا تعمدت أنت الاستفراغ، كأن أدخلت أصبعك في فمك، أو تعمدت شم رائحة كريهة لغرض التقيؤ، أو تعمدت رؤية شيء يستفز المعدة لغرض التقيؤ، أو استعملت أي وسيلة تريدين التقيؤ متعمدةً؛ فعليك القضاء بعد رمضان، وهذا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رواه الترمذي([1]).
([1])رجاله ثقات، رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان. وأعلّه الإمام أحمد والبخاري. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا، فليقض»، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ا.هـ.
الظاهر من سؤالك أنك تعمدت الاستفراغ لأجل معالجة التلبك الذي حصل لك في المعدة، وعليه فعليك قضاء هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رواه الترمذي([1]). والسين في قوله صلى الله عليه وسلم (استقاء) طلبية، أي تعمد التقيؤ، فيكون مفطرًا.
النخامة او البلغم من حيث ابتلاع الصائم لها فيه خلاف في القديم والحديث، والصواب من أقوال أهل العلم أن النخامة أو البلغم غير مفطر سواء تعمد الصائم بلعه أم لم يتعمد؛ لعدم الدليل على كونها مفطرة، ولأنها ليست غذاء، ولا في معنى الأكل والشرب، وأشبه شيء يمكن أن تلحق به هو الريق، وابتلاع الريق لو جمعه الصائم لم يفطر، ولذلك بلع النخامة لا يفطر، والاحتياط لك أن تلفظها إذا وصلت الفم إن استطعت، وإن لم تستطع وبلعتها فلا شيء عليك في أصح قولي أهل العلم.
هذا ذكرته تفقهًا، وليس فتوى، وإنما مباحثة مع الطلبة، وهو من أخرج لسانه وعليه الريق، ثم رده وابتلع ما عليه فهل يفطر؟ فيها قولان، ورجحت عدم الفطر.
ولذلك إذا مد الصائم لسانه وعليه شيء من ريقه، ثم رده مع الريق؛ فإنه لا يفطر، وأيضًا لو جمع ريقه، ثم أخرجه إلى طرف شفتيه، ثم ابتلعه؛ فإن صومه صحيح، لأن اللسان من الفم.
وعليه أنبه إخواني الصائمين الذين يكثرون من البصاق في نهار رمضان تحرزًا من الريق أو اللعاب؛ أن فعلهم هذا لا وجه له، وهو إلى التنطع أقرب.
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات وأكبرها إثمًا، وفيها الكفارة المغلظة، فإن حصل بينكما جماع في نهار رمضان عامدين غير ناسيين ولا مخطئين، فقد فسد صومكما، ويترتب عليك وعليه ما يأتي:
أولًا: التوبة إلى الله من هذا الفعل.
ثانيًا: يجب عليكما إتمام صوم ذلك اليوم من دون احتسابه.
ثالثًا: عليكما قضاءه بعد رمضان.
رابعًا: تجب على كل واحد منكما الكفارة المغلظة، وهي الوارد ذكرها في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا …” ([1]).
عليكما التوبة إلى الله من هذا الفعل، وعدم العود إليه مستقبلًا، والندم على ذلك، وأيضًا قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
وتجب على كل واحد منكما كفارة مغلظة واحدة فقط، وهي الوارد ذكرها في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا …” الحديث([1]).
أنت في مثل هذه الصورة لا تعتبر جاهلًا؛ لأنك تعرف الحكم الشرعي، ولا يلزم أن تعرف تفاصيل الحكم الشرعي؛ ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا …” ([1]) الحديث؛ دليل على أن الرجل لم يكن يعرف تفاصيل الكفارة، وإنما يعرف بأن الجماع في نهار رمضان حرام، فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك عليكَ الكفارة.
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات وأكبرها إثمًا، وفيه الكفارة المغلظة، فإن جامعت في نهار رمضان متعمدًا غير ناسٍ ولا مخطئ، مختارًا غير مكره، فقد أفسدت صومك سواء أنزلت أو لم تنزل، وعليك قضاء هذا اليوم والكفارة المغلظة، وهي الوارد ذكرها في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا …”([1]). الحديث.
والكفارة على الترتيب لا على التخيير في أصحّ قولي أهل العلم.
الاستمناء هو: إنزال المني باليد أو نحوها، وهو محرم، ويفسد الصوم في أصحّ قولي أهل العلم، وفيه التوبة وقضاء هذا اليوم فقط، والدليل على أن الاستمناء من المفطرات: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»([1]). وإنزال المني من الشهوة التي يشعر فيها المستمني بالتذاذ، ولذلك واجب عليه تركها.
([1])متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم تجوز المباشرة والقبلة للصائم إذا كان يملك نفسه، فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»([1]).
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَنَا صَائِمَةٌ»([2]). وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ»، ثُمَّ ضَحِكَتْ([3]).
أما إذا كان الصائم يعتقد أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يملك نفسه، وربما يتطور الأمر إلى الجماع، أو الإنزال فلا يجوز، لأن للوسائل حكم المقاصد، وقد فرَّق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بين الشَّابِّ والشَّيخِ، «فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ»([4]).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، «فَرَخَّصَ لَهُ»، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ»، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ([5]).
([2])صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى.
([3]) متفق عليه واللفظ للبخاري.
([4])صحيح، رواه مالك في الموطأ.
لا يجب عليك الصيام ما دام أنه يشق عليك ولا تستطيعنه، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وتنتقلين إلى البدل، وهو أن تطعمي عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»([1]). وينص الفقهاء على أن الإطعام هو: نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، والصواب هو إطعام مسكين ما يكفيه وجبة غداء أو عشاء مثلما يقدم الآن في المطاعم.
هذا قول معروف وموجود في كتب الفقه والأحكام، ولكن ليس هو القول الوحيد، فالمسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء، والصواب أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإن عليها القضاء فقط، حالهما في ذلك حال المريض الذي لا يستطيع الصوم أو يخشى على نفسه مضرة إن هو صام، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]
نعم، يجوز لك تذوق الطعام لهذا الغرض؛ بشرط التحفظ من دخوله شيء من الطعام إلى الحلق، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ، يَعْنِي الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا([1]).
وإذا كان هناك من يقوم بمثل هذا الأمر ممن لا يجب عليه الصيام فالاحتياط اجتنابه بالنسبة إليك، وإن لم يوجد فلا حرج.
([1]) أخرجه ابن أبي شيبة وعلي بن الجعد واللفظ له – ومن طريقه البيهقي- وفي سنده شريك بن عبد الله؛ فيه مقال، وعلقه البخاري تعليقًا مجزومًا به بلفظ: “لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ”. وقال الألباني في الإرواء: وهذا سند حسن في مثل هذا المتن. ا.هـ. ورواه ابن أبي شيبة من طريق جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ». وجابر هو الجعفي، وهو ضعيف.
مسألة استعمال الكحل للصائم في نهار رمضان من المسائل الخلافية:
فجمهور الفقهاء يمنعون الصائم من الاكتحال للنص والحال، أما النص فلحديث: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ». رواه أبو داود وغيره([1]). وأما الحال فقالوا: لأن في العين عروقًا تتصل بالحلق، والقاعدة عندهم أن كل شيء وصل إلى الحلق واختلط بالريق فأحس الصائم بطعمه؛ أفطر بسببه.
والقول الثاني -وهو الراجح- أن الاكتحال لا يفطر، وحجتهم النص والحال أيضًا، أما النص فلعدم وجود النص، والقاعدة الشرعية أن الترك دليل، ومعلوم أن الأصل الإباحة، والاكتحال كان موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للعلاج وللتزين، ولم يثبت عنه أنه نهى عنه، مع توافر الدواعي لنقل النهي، فقد نقل عنه ما هو أقل تنبيهًا من ذلك، وأما حديث أبي داود الذي استدل به الجمهور فلا ينتهض للاحتجاج لضعفه؛ ففي سنده ضعيف ومجهول. وأما الحال فنقول: إن العين ليست منفذًا إلى الجوف مثل الفم والأنف ولو كان فيها عروق تصل إلى الحلق، لكنها ليست منفذًا إلى الجوف، وعليه فيجوز للصائم الاكتحال، والأولى تأخيره إلى الليل خروجًا من الخلاف.
([1])حديث ضعيف الإسناد، أخرجه أبو داود والطبراني والبيهقي، وفي إسناده عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؛ ضعيف، ووالده النعمان بن معبد مجهول. وقال أبو داود عقبه: ” قال لي يحيى بن معين: وهو حديث منكر”. وانظر: السلسلة الضعيفة (1014).
صومك صحيح ما دام أنك قد نويت الصيام من الليل قبل الصبح، فليس من شروط صحة الصيام الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ففي الصحيحين أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَتَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وفي رواية: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ».
كره بعض الفقهاء السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ»([1]) .
قالوا: فإذا استاك الصائم ذهبت هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، والواقع أن هذا مردود نصًا وحالًا.
أما النص فلما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»([2])، وفي رواية: «..لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»([3])، وغيره من الأحاديث التي لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الصائم عن غيره. وأما الحال فإن الخُلوف تغيّـر رائحة الفم، وسببه خلو المعدة من الطعام، ويبسها هو الذي يسبب هذه الرائحة، فيجوز لك استعماله، وأيضًا يجوز استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام بشرط التحفظ من نزول شيء إلى الجوف.
([1])متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([2])متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري.
([3])علقه البخاري. وقال الحافظ في الفتح (4/ 159): وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ …بِهَذَا اللَّفْظِ … وَأخرجه ابن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ». وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا … عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».
لا شك في أنك أخطأتِ خطأ كبيرًا، وكان الواجب عليك ألّا تتصرفي مثل هذا التصرف إلا بعد سؤال أهل العلم، فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء في أصح قولي أهل العلم، والمتوضئ مأمور بالمضمضة والاستنشاق حال الصيام وغير الصيام، إلا أنه لا ينبغي في حال الصيام أن يبالغ فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»([1])؛ بل نص الفقهاء على إباحة ترطيب الفم والشفتين بالماء إذا احتاج إليه الصائم.
([1]) صحيح، رواه الخمسة من حديث لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه.
نعم، فإن أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع والاستفراغ، وقد جمع الله تعالى المفطرات الثلاث الأولى بقوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]
وأما الاستفراغ، وهو التقيؤ؛ فقد ثبت في السنة النبوية أنه من المفطرات، وعليه فيمكن أن يقال بأن المفطرات سبع:
- 1- الجماع.
- 2- والاستمناء، ومعناه: إخراج المني باليد ونحوها.
- 3- والأكل.
- 4- والشرب.
- 5- وما كان بمعنى الأكل والشرب مما يتعاطاه الإنسان مما يدخل إلى الجوف أو عبر الأوردة أو بقية البدن كالإبر المغذية وغيرها.
- 6- ومن المفطرات التقيؤ المتعمد.
- 7- وأيضًا الحجامة في أصح قولي أهل العلم.
وإذا حاضت المرأة أو نفست فإنهما تفطر، ولا يجوز لها الصيام وعليها قضاء ما أفطرته من الأيام.
إخواني وأخواتي قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أعطيكم قاعدة عامة تنتفعون بها، وهي أن جميع الحقن والتحاميل التي يستعملها الصائم سواء التحاميل الشرجية أو المهبلية، وكل دواء يستعمله الصائم في السبيلين ( القبل والدبر) لا يفطر.
وعليه فإن هذه التحاميل لا تفطر؛ فهي تحتوي على مواد علاجية دوائية فقط، وليس منها سوائل غذائية، فليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، وأيضًا المحل الذي توضع فيه ليس طريقًا إلى الجوف الذي قصده الشارع الحكيم كما بينت في أول الجواب.
نعم غسيل الكلى المعروف يفطر الصائم؛ لأنه يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وهنا نصيحة لإخواني وأخواتي، بارك الله فيكم، وشفى الله جميع مرضى المسلمين؛ بالنسبة للمريض قد رخص الله جل وعلا له بالفطر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]
وبعض الأمراض قد توجب على الصائم الفطر، ولا يجوز له الصيام؛ خاصة مثل هذه الأمراض التي يحتاج فيها المريض إلى السوائل وتناول الأدوية، أقول هذا الكلام لأن بعض المرضى قد رخص الله له وهو يأبى أن يأخذ برخصة الله، فيتضاعف عليه المرض، وقد يضجر من العبادة أو يقول: سبب ذلك العبادة، وبعضهم قد يهلك، والله جل وعلا ما كلّفه ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقاعدة الشريعة أنه “لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة”.
أريد أن أوضح مسألة تلتبس على كثير من الصائمين، وهي عدم التفريق بين بخاخ الأنف وقطرة الأنف. أما بخاخ الأنف فيجوز للصائم استعماله فهو يشبه بخاخ الربو، وأما قطرة الأنف فلا يجوز للصائم استعمالها؛ لأنها تسيل، والأنف مدخل إلى الجوف، إلا إذا كانت نقطة أو نقطتين، ونهايتها الخياشيم مثلًا، والمستعمل لها متيقن أنها لا تذهب إلى الجوف؛ فإنها لا تفطر.
الكلام في صوم المسافر وفطره لا يدور في وجوب صومه أو عدم وجوب صومه، ولا في كون وسيلة السفر مريحة أم غير مريحة، فإن الشارع الحكيم جعل علة الفطر في السفر هو مجرد السفر، وليس المشقة، ولا نوع وسيلة السفر، قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، وإنما الكلام يبحث في الأفضيلة، فالأفضل في حق الصائم الفطر في السفر مطلقًا، ويقال لمن صام: لا حرج عليك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، بل قد يتأكد الفطر في أحوال، منها في حق من وقع في مشقة وحرج وهو مسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلًا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِن البرِ الصومُ في السفر»([1])، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤتى رُخُصه، كما يكره أنْ تُؤتى معصيته »([2])، وفي لفظ: «كما يُحبُ أنْ تُؤتى عزائمه »([3]).
([3])رواه ابن حبان ، وابن أبي شيبة.
لقد بين الله جل وعلا حقيقة الصيام بقوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة: 187]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»([1]).
فجعل الشارع الحكيم الصوم ما بين هذين الوقتين، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأنتم في مثل هذه الصورة لا يجوز لكم الفطر ما دامت الشمس لم تغب، فالشمس ما زالت باقية».
صومكم صحيح، ولله الحمد، وأكملوا أكلكم؛ لأنكم أفطرتم بنص شرعي، وهو غروب الشمس عليكم، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة: 187]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم». متفق عليه. وأما طلوع الشمس بعد إقلاعكم بالطائرة فأنتم الذين طلعتم على الشمس، وليست الشمس هي التي طلعت عليكم.
: لقد رخص الله للمريض والمسافر بالفطر، قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185]، ولم يأت نص في بيان نوعية السفر، من حيث المشقة وعدم المشقة، ولا في حال المسافر؛ من حيث كونه محترفًا السفر أم لم يكن محترفًا، فما دام الإنسان مسافراً؛ سواء كان سفره طارئًا أم دائمًا؛ كالسائفين المحترفين لسيارات الأجرة أو الشاحنات، أو قائدي الطائرة أو الباخرة أو القطار أو الباص وغيرها؛ فإنهم يترخصون برخص السفر من قصر الصلاة، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وأيضًا الفطر في رمضان، وعليهم القضاء.
هذه المسألة من المسائل الخلافية في القديم والحديث، فلقد اختلف فيها العلماء اختلافًا طويلًا، فمن أهل العلم من حددها بمسافة محددة، بنحو ثلاثة وثمانين كيلومتراً، أو ثمانين كيلومتراً، ومنهم من حددها بما جرى عليه العرف أنه سفر، وإن لم يبلغ هذه المسافة؛ قالوا: لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة؛ بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلّى ركعتين، وعليه فإذا فارقت عامر بنيان بلدك، وأنت عازم على السفر، وقد جدّ بك السير، فلك أن تفطر ولو كنت تشاهد بنيان بلدك، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم.
يفطر الصائم إذا غربت الشمس، ويتحقق غروبها بتحقق غياب قرص الشمس في جهة الغروب، ولو بقي شيء من الضوء الذي يخلفه غياب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة: 187]، وَفي الصحيحين عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»([1])، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا([2])». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ، بِيَدِهِ: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»([3]).
([1]) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
([2]) قوله: (فاجدح لنا) هو: بِالْجِيمِ ثُمَّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْجَدْحُ تَحْرِيكُ السَّوِيقِ وَنَحْوِهِ بِالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَالُ لَهُ الْمِجْدَحُ، مُجَنَّحُ الرَّأْسِ. والسويق: هُوَ الْقَمْح أَو الشَّعِير الْمَقْلِيُّ ثمَّ يطحن. قال الحافظ: وَقَدْ وَصَفَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: عُدَّةُ الْمُسَافِرِ، وَطَعَامُ الْعَجْلَانِ، وَبُلْغَةُ الْمَرِيضِ. ا.هـ.
من السنة تعجيل الفطر وعدم تأخيره، وهي مسألة لها ارتباط بالسنة الكونية القدرية في الخلق من حيث الخيرية وعدمها، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»([1])، ولما ثبتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ»([2]).
وأما قول السائل: “من باب الاحتياط“؛ فالذي يظهر أن هذا من قبيل الوسواس والمبالغة، والآن، ولله الحمد، أصبحت هناك وسائل كثيرة تساعد على معرفة غروب الشمس، منها الأذان الذي يرفع عبر هذه المكبرات التي تسمع من مكان بعيد، وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تسهم إسهامًا كبيرًا في معرفة غروب الشمس، وأيضًا التقاويم المعدة مسبقًا، فلا يوجد داعٍ لهذا التأخير في الإفطار.
([2])حديث حسن صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي في الكبرى وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حِبَّان والحاكم.
الأفضل الفطر بمجرد غروب الشمس، ومن ثم تصلون المغرب؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه رضي الله عنهم؛ فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ…». الحديث([1]). وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ كَانَ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ»([2]).
وهو ما كان يحثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل الإفطار؛ فعن ابــــنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّا – مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ- أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُورَنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنِا فِي الصَّلَاةِ»([3]).
ويُروى مِنْ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»([4]). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا»([5]).
([1])حديث حسن صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([2])حديث حسن صحيح، رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في المعجم الأوسط، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
([3]) حديث صحيح، رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وابن حبان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ا.هـ.
([4]) ضعيف الإسناد، رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي: حسن غريب. وانظر: ضعيف الترغيب (649)، والمشكاة (1989).
([5]) حديث صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف، والفريابي في الصيام، والبيهقي في السنن، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ا.هـ. وصحح إسناده الحافظ في الفتح.
أفضل شيء يفطر عليه الصائم الرُّطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وله بعد ذلك أن يأكل ما يشاء. فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»([1]). والحُسْوة، بالضم: الجُرعة من الشراب. والحَسْوة، بالفتح: المرَّة الواحدة.
([1])حديث حسن صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورواه الضياء المقدسي في المختارة.
لا يخفى عليكم أن العلل في النصوص الشرعية إما أن تكون ظاهرة أو مستنبطة، وفي الإفطار على التمر والماء حكمة، فبالنسبة للماء العلة منصوص عليها، فَعَن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ، فَعَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ»([1]). وأما الرطب والتمر فيذكر الأطباء والفقهاء أن المعدة تحتاج إلى تليين بعد يوم من عدم الأكل والشرب، وهذا موجود في التمر والماء، وكذلك انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم فترة الامتناع عن الطعام والشراب، وأن التمر يعوض ذلك، وهو أنفع من غيره. والله أعلم.
([1])ضعيف الإسناد، لجهالة الرّباب الراوية عن سلمان عمها. ويشهد له ما قبله. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال في موضع آخر: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. ونقل الحافظ تصحيحه في التلخيص عن أبي حاتم الرازي. وانظر: إرواء الغليل (4/50).
يدعو بما ورد، فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»([1]).
([1]) حسن، رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: إسناده حسن.
السحور سنة، وهو محل إجماع لمن أراد الصيام، فعن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»([1]).
أكل السحور سنة، وهو من علامة الخيرية لهذه الأمة، ولا ينبغي تركه ولو بجرعة ماء أو تمر، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»([1]).
وروى البزَّار عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نِعْمَ السَّحُورُ بِالتَّمْرِ»([2]).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “تسحَّروا ولو بجُرْعةٍ من ماء”. رواه ابن حِبَّان، ولذلك نص الفقهاء على أن أقله جرعة ماء.
([1]) صحيح، رواه أبو داود، وابن حبان.
([2]) حسن في الشواهد. كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 465)، ورواه ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في الحلية. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. ا.هـ. وفيه نظر، وانظر «الصحيحة» (562).
نعم، ثبت أن السحور بركة؛ فعن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»([1]).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهُ»([2]).
وقد ذكر العلماء معنى البركة في السحور، وأنها تحصل بجهات متعددة، منها:
- اتباع السنة.
- ومخالفة أهل الكتاب.
- ودعاء الله وملائكته للمتسحرين، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»([3]).
- والتقوي به على العبادة.
- والزيادة في النشاط.
- ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع.
- والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل.
- والتسبب بالذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة.
- وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.
- وأيضًا دعاء الملائكة للمتسحرين، وغيرها.
([2]) حديث صحيح، رواه النسائي، وأحمد، وحسّن إسناده المنذري في الترغيب.
([3])حديث حسن صحيح، رواه ابن حبان، والطبراني في الأوسط. وانظر: “الصحيحة (1654، و3409)”.
تأخيره أفضل إلى قبل طلوع الفجر، لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ». قِيلَ لأنس: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟”. قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»([1]).
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وأيضًا عن القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». قَالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا([2]).
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، رضي الله عنه، قَالَ: «كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »([3]).
إنّ أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أنه أرشد من كان إناء الماء في يده وسمع الأذان للفجر أن يكمل شربته، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»([1]).
([1])حديث حسن الإسناد، رواه أبو داود، وأحمد، والدارَقُطني، وقال: حديث حسن، وصححه الحاكم.
هذا الفعل خطأ، والتزامه إلى البدعة أقرب، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة: 187]، وقد دلت السُّنة النبوية على أن الأفضل للصائم أن يؤخِّر سُحوره إلى قبيل طلوع الفجر، وأن له أن يؤكل ويشرب حتى يسمع الأذان، فَعَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَعن القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». قَالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا. متفق عليه.
وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا «يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ»، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: «كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم». رواه مسلم.
الأفضل أن تتسحر أولًا ثم تغتسل بعد ذلك؛ لأن وقت الاغتسال واسع ولو طلع الفجر عليك، فلا يؤثر في صومك، أما وقت السحور فيفوت بالأذان، ففي الصحيحين أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَتَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وفي رواية: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ».